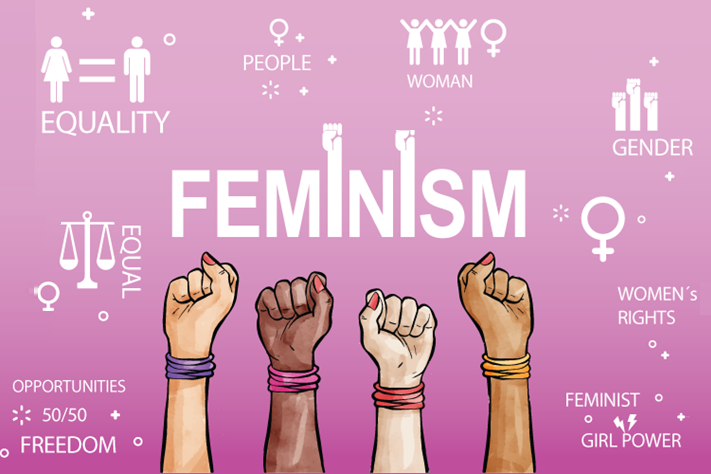على مدى العقدين السابقين، أصبحت أفكار وطروحات وممارسات ما يطلق عليه في الغرب الحركة النسوية أو (الفيمينزْم) تمثل تيارًا قويًّا وسائدًا في الحياة الاجتماعية والثقافية بل والسياسية، ويجد المتابع هذا الأثر في العديد من دور النشر المخصصة لنشر هذه الأفكار في عشرات الكتب الصادرة للترويج ونشر تلك الأطروحات، كما يجده في جمعيات اجتماعية وفكرية نشطة، وفي دوائر ذات نفوذ داخل المعترك السياسي، تعمل على تحويل الأفكار والطروحات النظرية إلى واقع عملي، من خلال استصدار القوانين والتمكين الاجتماعي للممارسات النسوية، عبر وسائل الإعلام الطاغية التي تشكل الرأي العام.
وبما أن الفيمينزم قد أصبحت في الغرب -وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص- أشبه بالأيديولوجية الفكرية التي وجدت فيها الليبرالية العلمانية تجديدًا لدمائها، فقد سرت هذه الأيديولوجية بشكل واضح ومتحمس من خلال مؤتمراتها عن المرأة والسكان والعقود التي كرستها للمرأة والطفل، وكانت الصياغة اللغوية مثلاً لوثيقة مؤتمر السكان العالمي الذي عقد بالقاهرة خلال شهر سبتمبر في العام 1994م منشورًا نسويًّا خالصًا، تجلت فيه -في عباراته وكلماته- معظم دعاوى ومفاهيم تلك الحركة؛ مما مثَّل وصولاً للأيدلوجية النسوية الغربية إلى مستوى الطرح العالمي، لتكون نمطًا في الأفكار والقيم والعادات والممارسات، يراد فرضه وتعميمه في الدنيا بأسرها.
تمرد على الأطر المرجعية
إن الحركة النسوية في الغرب التي يراد لها الآن أن تصدر إلى العالم كله؛ لتصبح نموذجًا عالميًّا، ينبغي أن تُفهم في إطار نشأتها الاجتماعية والفكرية والثقافية، وفي إطار الروافد الثقافية التي غذتها، والأوضاع الحضارية العامة التي أفرزتها؛ ذلك لأن هذا الفهم هو الذي يعصم العقل من الدعوى التي تزعم أن هذه الحركة ليست أيديولوجية نسبية ثابتة في بيئة فكرية واجتماعية معينة وخاصة، بل إنها فلسفة مطلقة عالمية صالحة لكل زمان ومكان، أو هي نموذج مطلق للسلوك البشري بعامة.
والحق أن الفيمينزم في هذا التطور تكرر ما حدث للأيديولوجيات الغربية السابقة من ليبرالية واشتراكية وبراجماتية، والتي طُرحت على العالم ليست باعتبارها اتجاهات خاصة بالحضارة الغربية، بل باعتبارها مذاهب مثالية وعالمية ونماذج تطبيقية، تسري على كل البشر رغم اختلاف حضاراتهم وعقائدهم. وهذا الإطار للفهم الذي نلمّح إليه معقد ومتشعب، لكن أول وأهم ما يمكن أن يقال عن الفيمينزم: إنها على عكس ما يفهم بعضهم في العالم الإسلامي -وهم يريدون من خلال هذا الفهم إحداث نوع من التمازج أو التقارب بين أفكارها وبين التعاليم الإسلامية تحت شعارات، مثل: تحرير الإسلام للمرأة- ليست حركة تهتم بحقوق المرأة، أو توفير العدالة والإنصاف لها، فالحديث عن حقوق المرأة والعدالة في تحسين وتصحيح أوضاعها هو حديث جزئي، بل لا معنى له في ظل أفكار الفيمينزم؛ ذلك لأن الحقوق والعدالة لا يمكن أن يكون لها معنى بمعزل عن إطار مرجعي وقيمي ومفاهيمي عام، يحدد ماهية تلك الحقوق وطابع العدالة ونوعها، والفيمينزم في هذا الصدد لا تعترف بأي إطار مرجعي عام في مجتمعها أو حضارتها، بل هي تزعم أنها تحدد وتنشئ إطارًا مرجعيًّا عامًا جديدًا في السياق الغربي.
ومن هذا فالحركة النسوية ليست امتدادًا -كما يحاول أن يوحي بعضهم إما بجهل أو بسوء نية- لحركات ظهرت في الغرب خلال القرن الماضي، تريد انتزاع حق التصويت للنساء في الانتخابات، أو حقوق الملكية والتعليم والعمل. ومن باب أولى فإن الفيمينزم لا يمكن أن تكون هناك رابطة أو صلة بينها وبين حركات ودعوات ظهرت في بلدان إسلامية في مطلع القرن الحالي؛ لتنادي بحقوق المرأة في ظل الإسلام، وتطالب بتحسين أوضاعها وفق القيم التي أرساها هذا الدين الحنيف.
إن الفيمينزم في جوهرها أطروحة جذرية ترفض أن تدافع عن حقوق المرأة، وفق الإطار القيمي الذكري أو الرجالي أو الأبوي السائد كما يصفونه، وهي تسعى في أفكارها إلى طرح إطار مرجعي عام بديل هو الإطار النسوي.
النسوية والفلسفات الغربية الكبرى
وهنا نصل إلى كنه الفيمينزم ووضعها داخل السياق الفكري والثقافي الغربي العام، إنها سعي إلى قلب كل التصورات الاجتماعية والقيمية، بل والأدبية واللغوية التي تسود في الغرب عبر إدخال منظور جديد، أو معيار ظل -في تصورهم- مكبوتًا حتى الآن، ألا وهو المنظور النسوي الذي ينبغي أن يعاد تفسير وكتابة كل التاريخ البشري الاجتماعي والفكري، وحتى الاقتصادي من منطلقه، وباعتماده إطارًا مرجعيًّا مطلقًا.
والفيمينزم في هذا لا تختلف عن فلسفات غربية سابقة سعت إلى قلب جذري للمفاهيم والأوضاع، من خلال إدخال منظور جديد لرؤية الأمور وتحليلها، ولعل أشهر هذه الاتجاهات هو النزعة الإنسانية (الهيومانيزم)، التي سادت ما يسمى بعصر النهضة في أوروبا، وأحلت الدنيوي (أو العلماني) محل الديني، أو الليبرالية التي أحلت البورجوازي محل الأرستقراطي محورًا للتفسير، أو الماركسية بإرجاعها كل الأمور البشرية إلى المعيار المادي الاقتصادي. إلا أن الفيمينزم تزعم لنفسها تميزًا في هذا الصدد، حيث ترى أن كل الحركات السابقة -البراجماتية أو الفلسفات الوجودية مثلاً- كانت تغيرات جذرية في المنظور، ولكن داخل إطار قيمي مرجعي أعلى واحد لم يتغير هو الإطار الذكري.
أما الفيمينزم فتعتبر محاولة تتجاوز كل محدوديات الفلسفات السالفة الذكر في أنها تغير وتبدل الإطار العام الذي حكم تلك الفلسفات. ولكن رغم هذه الدعوى العريضة، فإن الدراسة السريعة لمحتوى أفكار الفيمينزمنزم تكشف عن أنها استعادت وأخذت بشكل انتقائي من أفكار تلك الفلسفات الذكرية الطابع، بحيث يمكن القول بأنه لولا تلك الفلسفات لما نشأت الفيمينزم، وأنها تمثل امتدادًا للسياق العلماني العام، الذي هيمن على الفكر والحضارة الغربية منذ عصر النهضة.
فعلى سبيل المثال أخذت الفيمينزم من الليبرالية ذلك الإحساس المفرط بذاتية الفرد الإنساني، منعزلاً عن السياق الاجتماعي والديني، وإن كانت قد صبت هذا الإحساس على المرأة وليس الرجل، وأخذت من الماركسية بعض الشعارات الثورية وتحليل الاستغلال الاقتصادي، مع تطبيق هذه المصطلحات والتحليلات على المرأة في الغرب، وليس على الطبقات الاجتماعية وأشكال الإنتاج المادي، وأخذت من بعض مدارس التحليل النفسي مفاهيمها في نشأة الهوية الجنسية وتطورها، ولكنها طورتها لكي تتخذ منها مبررًا للدفاع عن مفهوم استرجال المرأة وتخنث الرجل؛ مما يمهد لظهور جنس ثالث يخرق كل المواصفات المستقرة حول طبيعة كل من الرجل والمرأة. وأخذت كذلك من فلسفة “نيتشه” وبعض الفلسفات المعاصرة كالبنيوية والتفكيكية مبدأ النسبية وتحطيم المطلق، لكي تتوصل من ذلك إلى نسف وهز الأسس الفكرية للمجتمع الذكري كما تسميه، تمهيدًا لإنشاء وإقامة طروحاتها التي تريدها أطرًا مطلقة، مهيمنة وسائدة.
ردة فعل للسياق الحضاري والعقائدي
وإذا كانت العلاقة مع الفلسفات الغربية الكبرى تحدد موقع الفيمينزم الفكري من خلال آليات المعارضة والاستعارة والامتداد المقلد، فإن محددات أخرى لهذه الأطروحة لا يجب إغفالها، لاسيما وأن هذه المحددات خاصة بالتجربة الغربية العقائدية والحضارية، وأنها هي التي ترسم للفيمينزم مجالها الخاص باعتبارها أيدلوجية غربية بحتة، لا يجب ولا يمكن أن تمتد لتطرح باعتبارها رؤية عالمية شاملة لكل البشر، فمن هذه المحددات تصور الفكر الغربي العام للمرأة، ذلك التصور الذي حددته الفلسفات اليونانية والكنائس النصرانية والمفاهيم اليهودية، ثم نقحته الأفكار الإنسانية العلمانية.
ومن هذه المحددات الكبرى وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي على امتداد القرون، وما شابه في القرون الأخيرة من مشكلات مع تعقد أنماط الحياة الغربية بفضل الثورة الصناعية ونتائجها. وجلي أن هذه الفلسفات والقيم والأوضاع تختلف اختلافًا جذريًا ونوعياً عن مثيلاتها في الإسلام، وفي خبرة المجتمعات الإسلامية التي حددت أوضاع المرأة، وحتى لو تقبلنا الطرح القائل بوجود مشكلة للمرأة أو قضية للمرأة في إطار المجتمعات الإسلامية، فإن الحقيقة تبقى أن هذه المشكلة والقضية تختلف في تكييفها عن مشاكل وقضايا المرأة في الوسط الغربي، كما تختلف في الإطار القيمي الذي تطرح من خلاله، والحلول التي يمكن أن توجد لها في ظل هذا الإطار كما نجده في الغرب.
لقد طرحت الفيمينزم نفسها في البداية كاستجابة ومخرجًا من الأوضاع التي تحكم حياة المرأة الغربية في الأوقات المعاصرة، وردًا على ما حللته بأنه ظلم المفهوم (اليوناني، الروماني، النصراني)، الذي ظل يحدد كيان وهوية المرأة على مدى حياة الحضارة الغربية، وهي في هذا أوحت في الفترة المبكرة بأنها امتداد لبعض الحركات النسوية السابقة التي دعت إلى تحرير أو انعتاق أو حقوق المرأة في بعض النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن مع تطور واتساع الحركة فكريًّا، وتزعم بعض العناصر اليهودية والراديكالية لطروحاتها، ظهرت أبعاد الفيمينزم الحقيقية التي ألمحنا إلى طرف منها فيما سبق، كما ظهر طابعها العنصري الذي يتخذ من معاداة الرجل محور الانطلاق الأساس، ويشعل نيران الحرب العنصرية بين الرجال والنساء في حرب مستعرة، لا ترضى بأقل من إخضاع الرجل، الذي يعامل في الفيمينزم كجنس مطلق وشرير، وتغيير طبيعته لكي يكتسب الأنثوية الرقيقة المستسلمة، في الوقت الذي تسيطر فيه المرأة باعتبارها هاجسًا مطلقًا، بعد أن تكتسب خصائص الاسترجال والذكورة مثل: القوة والشراسة والهيمنة.
هذا هو الهدف الأسمى للفيمينزم أو الفردوس الأرضي الموعود، كالفردوس الماركسي للبروليتاريا، وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف وضعت المفاهيم الجذرية للعلاقات بين الجنسين، واستعيرت الأفكار التي تنسف المطلق وتروج للنسبية، ونشطت عملية قلب وعكس القيم تحت دعوى الانطلاق من المنظور النسوي في مواجهة الذكري.
أيدلوجية تغريبية مقصودة
انتهت الفيمينزم في الغرب -أو كادت- منذ سنوات باعتبارها حركة فكرية نشطة، ولكنها مع هذا الموت أو التجمد الفكري بقيت مترسخة هناك باعتبارها مذهبًا أو أيدلوجية لها أتباع، وارتبطت بمصالح مادية وإعلامية وسياسية، وتيارات اجتماعية تعادي الأديان والعقائد، وتروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي.
وكما هو الحال بالنسبة للفلسفات الغربية السابقة التي تحولت إلى هذا المصير، بدأت الدوائر الحاكمة ذات النفوذ في البلدان الغربية الكبرى تنظر إلى الفيمينزم على أنها سلاح أيدلوجي ضد الخصوم والقوى الحضارية التي يتوجس الغرب منها، وبدأت الفيمينزم أداء هذا الدور في الثمانينات أولاً ضد الماركسية الثورية، ولكن بعد انتهاء قوة الشيوعية ظهر دورها الأساس في المرحلة الحالية سلاحًا فكريًّا يواجه قيم وتعاليم ومفاهيم وتصورات الإسلام.
ومن هنا بدأ طرح الأيدلوجية النسوية من خلال منابر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتجد طريقها إلى ما يسمى بدول العالم الثالث ومعظمها في الحقيقة دول إسلامية، بل إن هذه الدول بالذات هي المستهدفة خصيصًا من ترويج وفرض هذه الأيدلوجية، باعتبارها نموذجًا اجتماعيًّا سلوكيًّا يراد له أن يسود؛ ليدمر قيم الإسلام وممارساته وسلوكياته.
ولكي تؤدي الفيمينزم دورها بشجاعة شكلت منها -كما حدث مع الفلسفات الغربية السابقة التي صُدّرت إلى العالم- نسخة تصديرية، تشبه تلك النسخ التصديرية من أنواع السلاح أو الآلات المتقدمة التي لا يصدرها الغرب إلى البلاد الإسلامية، إلا بعد أن يدخل فيها تعديلات تسلب منها فعاليتها التقنية، وإن بقيت على شكلها الخارجي البراق والمتقدم، والنسخة التصديرية للفيمينزم نزعت منها دعاوى الشذوذ الجنسي واسترجال المرأة، وتخنث الرجل، وقلب الأدوار وإعادة تفسير التاريخ من المنظور النسوي في مواجهة المنظور الرجالي، وهذه النسخة صيغت في قالب الدعوة التي ألفها المسلمون من حقوق وحريات وإنصاف للمرأة، لكنها في الواقع بقيت في الجوهر محتفظة بهذه المفاهيم الأصلية لها، بحيث إذا تساءل إنسان عن نوعية هذه الحقوق والحريات والإنصاف المطلوب للمرأة في ظل الفيمينزم في نسختها التصديرية بإشراف الأمم المتحدة، لوجد أنها تكمن في الحرب العنصرية ضد الرجل وفي استهجانه، وإبعاد الهداية الدينية والتوجيهات الإسلامية، وفي عكس الأدوار وصولاً إلى مجتمعات وثنية شائهة تشبه مجتمع قوم لوط.
الخلاصة
ومن هذا الإطار نفهم أن ما يحدث الآن مع الفيمينزم في العالم الإسلامي هو بالضبط ما حدث مع فلسفات سابقة، في إطار عمليات الإمبريالية الثقافية والغزو الفكري والإلحاق والتبعية، وتغريب وعلمنة المسلمين بالكامل ومحو هويتهم، فالتصدير والفرض للأيدلوجية النسوية من خلال آليات المنظمات الدولية والمعونة الغربية، يحدثان كما حدثا من قبل مع الماركسية والليبرالية، والمروجون أنفسهم من العملاء الذين يوصفون بالمفكرين والكتاب، الذين يدَّعون أن الفيمينزم حل سحري جديد، يروجون كما سبق أن روجوا للفلسفات الغربية الأخرى، والانبهار نفسه والاستخذاء الذي حدث مع المذاهب الفكرية السابقة الوافدة من الغرب يظهر الآن مع الفيمينزم، حيث نسمع عن اتجاهات للتلفيق والمواءمة تستعير من مصطلحات وشعارات الفيمينزم ما تحاول أن تضفي عليه الطابع والمفهوم الإسلامي.
وأصبحنا نقرأ كتبًا عن تحرير المرأة المسلمة، لا بتعاليم ومفاهيم الإسلام الواسعة المرنة والإنسانية، بل من خلال أطر الفيمينزم المرجعية؛ لتصبح المرأة المسلمة مجرد نسخة من امرأة الفيمينزم المشاكسة العدوانية المحاربة لجنس الرجال، والتي قد تقبل من الإسلام ما تراه يكرس لها حقوقًا، لكنها ترفض منه ما ترى أنه واجبات تكبلها. والمشكلة الأساسية وراء كل ذلك أن الفيمينزم تحولت من أيدلوجية غربية خاصة ذات سياق معين ومحدد، إلى برنامج وخطة عمل تطبيقية يراد لها أن تطبق على المسلمين لتحل محل دينهم، كما يراد لها أن تطبق بشكل مطلق وعام.
__________________
** المصدر: موقع لها أون لاين، 8/4/2014، بتصرف يسير.